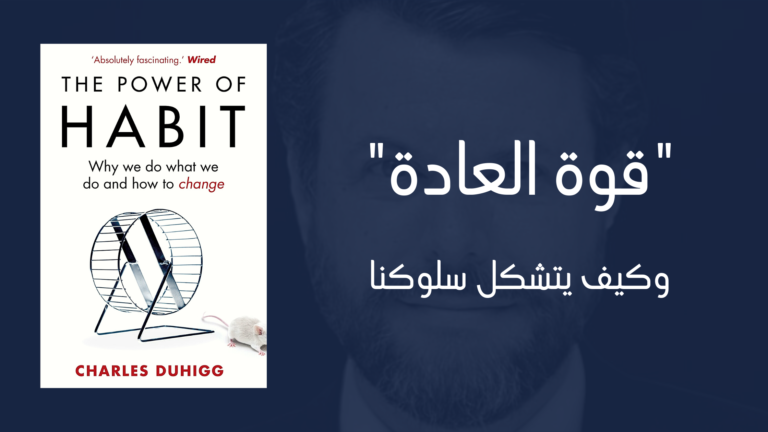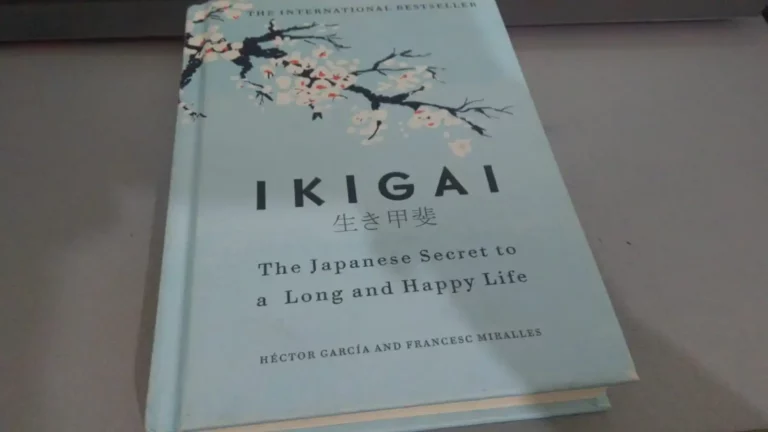يتناول الكاتب عقلية الإنسان الشرق أوسطي، بشيء من التحليل المبني على ملاحظاته وتجاربه الحياتية بمنظار علم الاجتماع، نسخة ابن خلدون، مضاف عليها تشاؤم الكاتب، بحكم تأثر الكاتب بابن خلدون بشكل أساسي، بالإضافة إلى تأثره بما دعاه بالـ”الحضارة الغربية” و”المنطق الحديث” وكذلك “الديمقراطية”، سأختصر ذلك بلفظ “الدعاية الأمريكية”؛ وهي الدعاية التي كانوا يروجون لها في القرن الماضي، من التغني بالديمقراطية وقوة الشعوب وسلطة العلم وما إلى ذلك.
برأيي؛ كتاب مهزلة العقل البشري كان تطبيقاً لمنظار ابن خلدون والدعاية الأمريكية على الشعب العراقي والعقلية الدينية الإسلامية في القرن العشرين، ضع ذلك في الخلاط والنتيجة كتاب مهزلة العقل البشري، والذي أعُدّه مهزلة هو الآخر، ومشكلتي مع هذا الكتاب تتلخص بخمس نقاط أساسيّة:
الفوضوية
كتاب بعنوان كهذا يمنح القارئ عدة توقعات، منها -كأبسط مثال- أن يكون الكاتب في وضع “عقلي” أعلى من الحالة التي وصفها بالمهزلة، أو على الأقل أن يكون الكاتب وجد المشكلة التي أدت إلى تلك المهزلة، حتى وإن لم يقدم لها حلاً.
ومن تلك التوقعات أن يكون الكتاب مكتوباً بشكل جيد، ولكن علي الوردي لم يرقى لتطلعاتي مع الأسف الشديد.
بمجرد اطّلاعك على قائمة المحتويات، ستلاحظ أن الكاتب لم يضع هيكلاً لكتابه، العناوين مبعثرة بشكل فوضوي، يمكنك وبكل تأكيد أن تختار أي فصل من الكتاب وتبدأ به، وستصل إلى المقصود، أو اقرأ الفصول بالعكس، لن تجد أي فرق في الفهم، فالكتاب لم يكتب بتلك الصيغة التي تعد من القوالب الأساسية في الكتب التعليمية، على الرغم من كون قالب كتابيّ كهذا متوقع جداً من دكتور في الجامعة كعلي الوردي.
الجهل المركب ووهم المعرفة
يرى الدكتور علي الوردي أن الفلسفة القديمة أو “المنطق القديم” أساس المهازل التي أصابت العقل البشري، ودائماً ما تجده يضع المنطق القديم في منافسة مع المنطق الحديث، ثم يجمع كلام رجال الدين الإسلامي في العراق مع الفلسفات الإغريقية وعلوم المنطق بكلمة “المنطق القديم” ويضع كل هذا الكوكتيل اللامتجانس في مواجهة مع المنطق الحديث المتمثل في الحضارة الغربية والديمقراطية والعلوم الطبيعية “الحديثة”.
هذا جهل، والمستفز أن صاحبه يفتخر بهذا الجهل في الفصل الثامن الذي سخره للدفاع عن السفسطائين:
وما درى أني أفتخر بأن أكون “سوفسطائياً” وعندي أن هذه السفسطة خير من هذه الخزعبلات المنطقية التي يتمشدق بها أصحاب المنطق القديم.
كما أنه يجهل أو يتجاهل الاختلافات الجوهرية بين المنطق اليوناني وما تلاه من الأنظمة المنطقية؛ التي يضرب بها السفسطائيون عرض الحائط بحجة أن الحقيقة لا يمكن الوصول إليها، كنوع من التجاهل المتعمد لوجود بعض الثوابت على الأقل، طالما أن هذا الفعل سيوصلهم إلى غاياتهم أياً كانت.
ففهمه عن المنطق الحديث والقديم بالأصل مغلوط، فقد وصف المنطق القديم في الفصل الثاني بقوله “كان القدماء يعتقدون أن الحقيقة واحدة وهي معلقة في الفراغ، ومعنى ذلك أنها ذات وجه واحد” أي قدماء تقصد دكتور؟
ثم وصف المنطق الحديث بعدها بقوله:
إن المنطق الحديث قد نسخ هذا المبدأ. فهو يرى بأن الحق لا يمكن أن يحتكره فريق من الناس دون فريق.
إن كان هذا مفهوم الكاتب عن منطق الأقدمين، فماذا عن قول جلال الدين الرومي:
كانت الحقيقة مرآة بيد الله، فسقطت وتحطمت. فأخذ كل فرد من الناس منها قطعة، ونظروا إليها، وظنوا أنهم يملكونها كاملة.
جلال الدين الرومي
هل هذا منطق حديث يا ترى؟
وكذلك تهجمه على علم الكلام لأسباب ما لم يوضحها:
قرأت مرة في بعض مؤلفات الخواجة نصير الدين الطوسي، كبير فلاسفة القرن السابع الهجري، فهالني ما وجدت فيه من أقاويل فارغة يطلق عليها اسم علم الكلام. مع العلم أن هذا الفيلسوف وصل في علم المثلثات إلى درجة من التفوق أذهلت علماء القرن العشرين.
برغم أن لعلم الكلام استعمالاته المحددة، ولكن طالما لم يجد استعمالاً اجتماعياً للعلم المذكور فسيعتبره “كخّة” أو درجة ثانية.
ونستطيع أن نستخلص من هذا أن المنطق السوفسطائي كان اجتماعياً، بينما كان منطق أفلاطون رياضياً. وشتان بين منطق الأرقام ومنطق البشر. إن الحقائق الرياضية خالدة تكاد تصلح لكل زمان ومكان. أما الحقائق الاجتماعية فهي متغيرة، وما يصلح منها اليوم قد لا يصلح غداً.
فمن غير المقبول أن يحط الشخص من شأن مجالات أخرى لأنه لم يجد لها فائدة في مجاله، وكأن السفسطة التي يدافع عنها كانت تأتي بالحلول لمشاكل العالم ولكن “الرياضيين” يرفضونها لتعنّتهم وعنادهم وكأنهم لا يريدون لمشاكل العالم أن تحل.
قد أتفهم منطلق الكاتب هنا، برغم أنه قاصر ومبني على عقد نفسية شرق أوسطية أصيلة، فالشرق أوسطيون يقدسون كبار السن بشكل مَرَضِي، وكبار السن في مجتمعنا من الملاحظ أن الغالب على سمتهم التعنت للأفكار القديمة، مهما بدا عوارها -والتي يرى الكاتب بينها وبين فلسفات الأفلاطونيين تشابهاً في طريقة السيطرة والتحكم بالآراء.
وأما الهجوم على علوم المنطق والفلسفات فهو غير مبرر، ويمكن رد آراءه بنفس منطقه الخاص الذي يتبناه -السفسطة- فطالما لا يمكننا الوصول للحقائق لأن الحقائق متغيرة -بحسب زعم السفسطائيين- فلم يجب أن نسلم بكلامك أساساً؟ ولم يجب أن نعتبر تنظيرك للأمور صحيحاً؟
فهذا الكلام جهل مركب؛ صاحبه جاهل لا يدري أنه جاهل، وطامة كبرى أن يخرج من شخص يحمل لقب دكتور جامعة.
نلاحظ أيضاً أن الكثير من اتهامات الكاتب للمجتمع حوله تنطبق على أفكار الكاتب نفسها، وقد أشار إلى ذلك على استحياء بضعة مرات، ومن ذلك الفصل السادس “القوقعة البشرية” الذي وصف فيها حال مجتمع الشرق الأوسط وما فيه من غرور، ووصف المشكلات التي يتحتم على البشر التعايش معها، ولو أنه قرأ شيئاً عن الـEgo في علم النفس، لفهم مدى ضيق أفقه وقلة علمه وفداحة خطئه في وصف المشكلة.
الافتراضات الهشة والسوداوية والعبثية
الظروف الاجتماعية التي كانت تحيط بالكاتب آنذاك -العراق في النصف الأول من القرن العشرين- من تخلف وجهل وتفشٍ للجهل المرتدي لرداء الدين عن طريق رجال -تجار- الدين، وكذلك طبع الكاتب التشاؤمي السوداوي بالإضافة إلى ما استشفه من أفكار ابن خلدون؛ شكلوا افتراضات بنى عليها الكاتب أفكاره -وقد نقول حياته- وهذه الافتراضات الهشة هي نتيجة لما وصفه الكاتب نفسه بالتقوقع الفكري أو “القوقعة البشرية”، وأرى أن صغر تجربة الكاتب ومحدودية أفقه أنتجا له تشاؤمه الذي يتغنى به في معظم الكتاب.
في الفصل الثاني “منطق المتعصبين” اقتبس الكاتب إحدى الفتاوى لأبي السعود العمادي -مفتي الدولة العثمانية في عهد سليمان القانوني- عن جواز قتال اليزيديين، والذي أفتى فيها المفتي آنذاك أن “قتلهم حلال في المذاهب الأربعة وأن جهادهم أصوب وأثوب من العبادات الدينية” وعلق عليها الكاتب بقوله:
إن هذه الفتوى الغاشمة تصلح أن تكون نموذجاً رائعاً لأسلوب المنطق القديم في التفكير
ولا أدري عن أي منطق يتحدث؟ المنطق الأرسطي يا ترى؟ فكيف يجعل فتاوى أساسها الوهم والكذب واحتقار الآخرين في كفة واحدة مع أنظمة التفكير التي ما تزال تستعمل حتى يومنا هذا؟
كذلك في الفصل السابع الذي سماه “التنازع والتعاون” والذي أفضل تسميته بـ “وهم الطبيعة البشرية” لما فيه من افتراضات غير مدعومة بأدلة ثابتة عن الطبيعة البشرية، فهو ينطلق من مبدأ:
والصحيح أنّ: الإنسان وحشي بالطبع ومدني بالتطبع.
كما أنه يعدّ رجال الدين في عصره من المفكرين:
إن مفكرينا، لا سيما رجال الدين منهم، يفضلون البحث في مجتمع خيالي…
وهذا أيضاً مما أضع عليه علامة استفهام.
وجمل مثل:
لا مراء أن ابن خلدون كان مخطئاً في كثير من آرائه. ولكنه رغم ذلك كان مصيباً كل الإصابة في أساس نظريته حيث نظر إلى الواقع الاجتماعي باعتبار أنه واقع محتوم لا مفر منه
كيف يستعمل الكاتب مصطلحات كـ”خاطئ” و”مصيباً كل الإصابة” وهو في نفس الوقت يؤمن بنسبية الحق والباطل؟
تلك الافتراضات الهشة التي بناها على تجربته المحدودة جداً، لم يأت بما يدعمها سوى نفس التجربة المحدودة، وبالتالي غفل الكاتب عن لب المشكلة وحقيقتها.
أما عن يأسه وسوداويته فنجدها في الفصل الرابع “عيب المدينة الفاضلة” الذي قدم فيه حججاً انتقد فيها فكرة المدينة الفاضلة، و منها حجج محترمة تستحق النظر، ولكن كل ذلك ينتهي عند حد سوداويته، فيقول:
الواقع أن البشر لن يصلوا إلى الأهداف الاجتماعية التي ينشدونها. فهم سيظلون دائبين في حركتهم نحو تلك الأهداف، وسر الحياة الاجتماعية كامن في تلك الحركة الدائبة.
والعبثية في قوله:
لقد ضربت الديمقراطية المنطق القديم ضربة لا قيام له بعدها. فليس هناك في نظر الديمقراطية حق مطلق وباطل مطلق على منوال ما كان القدماء يؤمنون به.
ليتك عشت لزماننا لترى ماذا فعلت الديمقراطية في بلاد الديمقراطية 🙂
العلموية على استحياء
“العلم هو المنهج الوحيد القادر على الإجابة على كل التساؤلات”، “أنا أصدق العلم” وغيرها من الشعارات التي تراها في الفيسبوك والنت عموماً، هي جزء من نتائج الدعاية الأمريكية في القرن الماضي لعلماء الفيزياء والكيمياء وغيرهم، ويبدو أن علي الوردي قد تأثر بهذه الدعاية تأثراً كبيراً، ونجد أنه كان يعلق آمالاً كثيرة على العلوم الطبيعية.
من المثير للسخرية أيضاً -للأسف- التنظير الفلسفي الذي مارسه على النظريات العلمية كنظرية النسبية الخاصة بآينشتاين برغم إنكاره على الفلسفات و”المنطق القديم”، فبأي حق يستعمل أدوات ينكر صحتها ويشنّع بأهلها لاستعمالهم إياها؟ ثم يستعملها -طبعاً- بشكل مخزٍ وخاطئ.
الثورية واليسارية السياسية
كحال أي مواطن شرق أوسطي يحكمه قطّاع الطرق، فعادة ما يميل هذا المواطن إلى قصص الأبطال الثوريين عبر التاريخ كالإمام الحسين والإمام علي وغيرهم، ويتأثر بقصصهم ويتغنى ببطولياتهم.
ولكن -وكحال أي مواطن شرق أوسطي- تتوقف المساعي نحو حل تلك المشكلة عند ذلك الحد، وتعود المشكلة للأرشيف -على رأي علي شريعتي- إلى خطبة الجمعة القادمة، وهكذا…
المشكلة في هذا التوجه، وكذلك طريقة التفكير الثورية أنها لا تقدم حلولاً فعالة، اعتراضك على صاحب المصنع الذي أنقص من أجرك في وطن مليء بالجوعى لن يعيد لك أموالك، بل سيطردك من عملك ويستبدلك بعامل جائع غيرك.
وعلى رأي أحد الأصدقاء، ثقافة الـ”احنا هنبات في الشارع عشان انتو مش بتجيبولنا ايسكريم وبنبوني.” لن تنفع أحداً، واليسارية وكذلك الديمقراطية يمكن ركوبهما بسهولة، ولن تنفع معتنقيها في شيء.
وكثير من آراء علي الوردي، كإعجابه بالإمام علي بن أبي طالب، وكذلك كراهيته لمعاوية، نابعان من ميوله الثورية اليسارية، ومع أن الحق والباطل في نظره نسبيان، ولكن في موضوع الحاكم والمحكوم يتحول الحق والباطل في نظر علي الوردي إلى حق مطلق وباطل مطلق… سبحان مغير الأحوال.
لا أتصور أن علي الوردي قدم شيئاً يستحق القراءة في هذا الكتاب، بنظري هو كتاب سيء. وأما القارئ غير المطلع فقد يرى فيه ما يسّره من معلومات لم يسمع بها من قبل كالفصل الحادي عشر الذي تناول الخلاف السني-الشيعي و دور الأمويين في إثارته، والفصل الثاني عشر الذي ذكر دور التدافع والخلاف في تكوين المجتمعات عبر التاريخ. وكتب التاريخ والعلوم تؤدي هذا الدور بشكل أفضل أساساً.
لذلك… قد تستفيد من كتاب كهذا إن كنت تعيش في القرن الماضي في نفس بلدة الكاتب، لكن ليس الآن.